
عروبة الإخباري –
قدّم رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الأستاذ الدكتور «محمد عدنان» البخيت طروحات قيّمة وثريّة خلال مشاركته في المؤتمر التسعين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، بكلمة حول «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي»، ضمن عنوان المؤتمر، الذي جاء هذا العام تحت عنوان «اللغة العربية وتحديات العصر: تصورات واقتراحات».
ووجه البخيت دعوةً لتشكيل هيئة عربيّة تُعنى باللغة العربية والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى الجهود العربية المتعثّرة، ومناقشًا موضوع الترجمة الآليّة وتحدياتها، والتطور الرقمي لبيانات النصوص الإلكترونية المخزّنة. كما تناول البخيت مواضيع ذات علاقة، منها مجالات الذكاء الجديد في التعليم المدرسي والجامعي، ومدى استعدادنا للثورة الرقمية الجديدة في ظلّ ذلك.
تاليًا نصّ الكلمة التي لقيت اهتمامًا إعلاميًّا وثقافيًّا في هذا الجانب:
اللغة العربية والذكاء الاصطناعي
أ.د محمد عدنان البخيت(رئيس مجمع اللغة العربية الأردني)
الحديث عن اللغة العربية والذكاء الاصطناعي يذهب بنا، بطبيعة الحال، إلى ما يُسمى بـ(حوسبة اللغة العربية)؛ أي تطوير برامج حاسوبية تخدم اللغة العربية في هذا المجال، وتتيح لها مواكبته، وقد تم العمل على ذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي من خلال ثلاثة مجالات:
– الإدخال؛ بتهيئة أجهزة الحاسوب لقبول المُدخلات باللغة العربية.
– المعالجة؛ بالقدرة على تحليل اللغة المُدخلة وفهم دلالاتها.
– الإخراج؛ باستجابة أجهزة الحاسوب على صورة مخرجات بالعربية أسوة باللغات الأخرى.
وقد تدرجت حوسبة اللغة في العالم في مراحل معروفة منذ ظهورها في منتصف القرن العشرين؛ أولاً من خلال تحقيق أهداف متواضعة أقرب إلى التخزين ثم الاسترجاع والتبويب، وصولًا إلى ما يمكن اعتباره اليوم «حواراً» بين الإنسان والآلة، أو «أنسنة الآلات» بالقدرة على محاكاة الإنسان في التعلم والإبداع وإنتاج المعرفة، وهو ما يعرف بـ(الذكاء الاصطناعي).
وبالنسبة إلى اللغة العربية، فلا بد من الاعتراف أنه على الرغم من «الجهود العربية» التي بُذلت لجعلها تواكب هذه الثورة، إلا أنها ظلت دائماً متأخرة بخطوة، بل بخطوات، عن اللغات الأخرى. والحقيقة الأخرى أن حوسبة العربية تدين أساساً للشركات العالمية في هذا المجال –وذلك لأسباب تجارية طبعاً- من خلال التطبيقات المعروفة في مناحي الحياة المختلفة.
وعلى الرغم من ذلك بقينا نحوم حول المعالجة غير العميقة للغة، من دون غوص في التحليل لفهم دلالاتها، بل ظلت تقنيات وموارد حوسبة اللغة العربية المستخدمة في تلك التطبيقات غير متاحة في مجملها خارج هذه الشركات، فنحن ما نزال عاجزين، مثلاً، حتى اليوم عن طباعة نص عربي على الحاسوب أو الهاتف، نلقي فيه التحية على صديق أو معرفة، من دون أن نلج أولاً عبر بوابة مايكرسوفت وجوجل وأبل!
الترجمة الآلية: كيف تجاوَزَت الصعوبات؟
من أهم المجالات المرتبطة بالتعليم وحوسبة اللغة العربية ما يُسمى (الترجمة الآلية) الحلم الذي أصبح حقيقة أكثر من أي وقت مضى؛ وحتى ندرك حجم القفزة التي تم تحقيقها في هذا المجال، يكفي أن نعود سنوات قليلة إلى الوراء لا تزيد على عشر؛ وتحديداً الدراسات والبحوث العربية ذات العلاقة، إذ قَلَّما كان يخلو أي منها من «سخرية» من النتائج التي كان يخرج بها مَن يلجأ إلى المترجمات الآلية المتاحة على الشابكة.
لكنّ كل هذا أصبح اليوم جزءاً من الماضي؛ وذلك بفضل التطور المذهل الذي عززه حجم المحتوى الرقمي على الشابكة، ودخول الذكاء الاصطناعي هذا المضمار، فانتفت الحاجة إلى ما يُسمى المحللات الصرفية والنحوية التي عمل عليها الباحثون والشركات سنوات طويلة دون أن تثمر نتائجَ مُرْضية.
«ساعد النمو المذهل لبيانات النصوص الإلكترونية المخزنة في الحاسوب في ظهور فكرة تحليل هذه النصوص إحصائياً لاستنتاج الأنماط والقواعد التي تحكم ترتيبها وتركيبها. وقامت برامج التحليل الإحصائي للبيانات الضخمة بتزويد الحاسوبيين بمعلومات وفرت عليهم في كثير من الأحيان عناء محاولة التقعيد اللساني لمحتوى هذه البيانات».
وحتى ندرك مقدار التطور الذي تحقق في هذا المجال؛ يكفي أن نلجأ اليوم إلى مترجم جوجل لترجمة جملة أو حتى فقرة كاملة؛ إذ تكاد نسبة الخطأ تقترب من الصفر.
على مستوى المدرسة والجامعة يمكن القول إننا وقعنا في «إساءة استخدام» لهذه النعمة، وتحديداً في مجال البحث العلمي؛ فمع الصعود الصادم لثورة المعلومات بدءاً من تسعينيات القرن العشرين، وتمثل ذلك أساساً بالانتشار التدريجي لخدمة الشابكة (الإنترنت) سعى العرب، كما ذكرنا، إلى إدخال هذه التقنية الجديدة في مجال التعليم، وكانت البداية مع توظيف إمكانياتها في تسهيل الوصول إلى المعلومات، لكن المؤسف، والطريف في آن، أنّ الأمر تحول إلى مظاهر شكلية لا تتفق بحال مع المطلوب؛ فأصبح طلبة المدارس يستخرجون مواد جاهزة من موسوعة (ويكيبيديا) وغيرها تفتقد إلى الموثوقية ولا تتطلب جهداً يُذكر.
أما على المستوى الجامعي فلا نذيع سراً إذا قلنا إنّ كثيراً من البحوث الجامعية ورسائل الدراسات العليا استغلت ثورة المعلوماتية في (السرقات العلمية) الجزئية والكلية؛ وهو ما دفع الجامعات للتصدي لهذه الظاهرة من خلال الاشتراك بخدمات كشف السرقات العلمية.
تدريجياً بدأنا نتكيف مع التطورات اللاحقة في المناهج المدرسية الجديدة التي تضمنت إحالات، من خلال رمزQR يمسحه الطالب بالهاتف الذكي فيذهب به إلى مواقع إلكترونية، بهدف تعزيز المعلومة الصفية لدى الطالب من خلال مقاطع مصورة تتعلق بمادة المنهاج.
لكن يبدو أن التسرع والشكلية ما يزالان سَيّدي الموقف؛ إذ لاحظنا أن هذه المقاطع في معظمها «جاهزة» ومجانية، وليست من إنتاج وزارات التربية والتعليم، ولذلك ضريبة؛ فلا يكفي أن تكون المادة متناسبة مع الهدف المرجوّ، إذ يمكن أن يواجه الطالب وهو يستمع إلى آيات من القرآن الكريم عبر (يوتيوب)، بدعاية أو منشور ترويجي لا يتناسب مطلقاً مع مرحلته العمرية، فضلاً عن قدسية النص نفسه!
مجالات الذكاء الجديد في التعليم
على الرغم من أن بعض الباحثين يذهبون إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يعود إلى ستينيات القرن الماضي للمساعدة في أَداء مهام إدارية ومن ثم تحليل البيانات المتعلقة بالطلبة وتقييم أدائهم، إلا أنه يمكن القول إن الاستغلال الحقيقي لهذه التقنية في جوهر العملية التعليمية بدأ مع انتشار خدمة الشابكة (الإنترنت) في التسعينيات الماضية.
اليوم يمكن تلخيص مجالات الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يأتي:
– تطوير مناهج تراعي مستويات الطلبة، وذكاءهم.
– توجيه الطلبة ودعمهم معرفياً بعد تحديد نقاط الضعف لديهم.
– مساعدة المعلمين في تتبع تقدم الطلبة للوصول إلى مجالات التحسين.
– إتاحة مسارات التعلم الشخصية حسب اهتمامات الطلبة.
– استخدام أحدث التقنيات التفاعلية في إيصال المعلومات بأسلوب جذاب.
الاستعداد للثورة الجديدة
كأي تغيير في التاريخ، من الطبيعي أن يُواجَه الذكاء الاصطناعي، بالتوجس والخوف، بل والمحاربة باعتباره مهدداً للأجيال القادمة ومخرّباً لأُسسها وقيمها التي قامت على الالتزام والتقليد.
لكن من الواضح أن أصحاب مثل هذه الآراء سيخوضون معركة خاسرة أخرى، كما جرى مع الطباعة قبل أكثر من قرنين، ثم بعد ذلك بقرن لتغيير المناهج لتواكب العلوم الأساسية والتطبيقية الوافدة، واليوم بعد أن كنا نَعُدّ ثورة الاتصالات والإنترنت نوعاً من الترف، أصبحنا لا نستغني عنهما في معظم مفاصل الحياة اليومية، ليس في الحاسوب القابع على المكتب وحسب، بل أصبحنا نحمل هذه التقنية بصورة أقرب إلى الإدمان مع انتشار الَّلوحِيّات والهواتف الذكية.
لا ننكر أن المخاوف بالنسبة إلى التعليم مشروعة نظراً إلى حساسية هذا المجال الذي يتعامل مع بناء الإنسان نفسه، وتكوينه المعرفي والثقافي، الذي سينعكس في النهاية على المجتمع والدولة ويحدد مساراتها ومصائرها.
الجديد أن «الرُّهاب الحاسوبي» الذي طالما عانت منها الأجيال السابقة، قد زال اليوم مع سهولة برامج التشغيل والتعامل مع التطبيقات الجديدة؛ سواء لدى الطلبة أم المعلمين والأهالي، بل قلما نجد اليوم من يعجز عن التعامل مع هذه التقنيات في الحد الأدنى من المعرفة المطلوبة. في ظل هذا الواقع نتساءل: من يتصدى لاستغلال هذه المعطيات وتوظيفها بالشكل الأمثل في التعليم؟
لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن ثمة جهوداً مبعثرة بتعدد الجهات التي تتعامل مع الموضوع من دون خط واضح يجمعها: جهود حكومية، قطاع خاص، مجامع وأكاديميات…
العالم لن ينتظرنا وسيمضي في تطوره، ويجدر بنا أن نسعى لمغادرة مقاعد المراقب والمتلقي إلى مواقع التأثير، على الأقل فيما يتعلق بلغتنا؛ لذلك نحتاج إلى رؤية واضحة للأجيال واحتياجاتها بالاتفاق على خطة استراتيجية شاملة تستوعب قدرات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وفي الوقت نفسه تستشرف المستقبل بالآفاق التي يتيحها في هذا المجال، والأهم أن نتعلم من أخطائنا التي أشرنا إلى جانب منها في موضوع حوسبة التعليم، وأن ندرك أننا اليوم أمام فضاء مفتوح بمعنى الكلمة، وأن لا مهرب من تسرب رياح العولمة الثقافية إلى باحاتنا.
آفاق واسعة وعقبات
إن أهم عائق يواجهه المعلم في إدارة العملية التعليمية وتحقيق رسالته هو الوقت؛ فهو في حاجة لاستغلال كل دقيقة للتواصل مع الطالب في سبيل إيصال المعلومة له، فضلاً عن دعمها بالنشاطات غير المنهجية؛ لكن كما هو معروف هو مضطر، لطبيعة عمله، للتعامل ضمن ما هو متاح له مع واجبات أخرى.
في هذا السياق يساعد الذكاء الصناعي المعلمين في التخفف من أعباء الأعمال غير التعليمية التي غالبا ما تستنزف قدراً لا يستهان به من أوقاتهم على حساب جوهر العملية التعليمية، إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة معظم المهام العادية، بما في ذلك العمل الإداري وتصنيف الأوراق وتقييم أنماط التعلم في المدارس والرد على الأسئلة العامة وغيرها من المهام الروتينية. إذ يمكن بمعرفة متوسطة في استخدام هذه التقنية التخلص من عبء التحضير للدروس وتصحيح الامتحانات، وتقييم الواجبات، والأعمال المكتبية، وإلقاء أعبائها على الذكاء الاصطناعي.
إذا أردنا أن نواكب هذه التيار الجديد في التعليم، يجب أولاً أن نعدّ المعلم ليكون قادراً على التعامل مع هذه الأدوات الجديدة، ليس لما ذكرنا فيما يتعلق بالأعمال الإدارية فقط، بل على مستوى أسلوب التعليم نفسه، الذي سيصبح ميدانا واسعاً للتميز إذا أتحنا للمعلم حرية الحركة في الوسائل التي يلجأ إليها ضمن ضوابط معروفة يحدها تحقيق الغايات والأهداف المطلوبة من المادة التي يُدرّسها.
من هذه الأساليب الجديدة التعلم التفاعلي؛ إذ تجعل الأدوات التكنولوجية التعلم أكثر تفاعلية وتشويقاً، حيث يمكن استخدام الألعاب والتطبيقات التفاعلية لتشجيع الطلاب على المشاركة وتعزيز تجربتهم التعليمية.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح المعلمين فكرة واضحة للموضوعات والدروس التي يجب إعادة تقييمها ويسمح هذا التحليل بوضع أفضل برنامج تعليمي للطلاب. ويتم الحديث في هذا المجال عن إمكانية التوسع في الدروس الإضافية لتقوية وتنمية مهارات الطلاب في دروس بعينها حسب الاحتياج الفردي، بحيث تتباين حسب تقييم كل طالب في سبيل دعمه في مواطن الضعف دون أن يؤثر ذلك في بقية زملائه ممن لا يشاركونه هذه المشكلة، بل يمكن تكييف المادة العلمية والعملية التعليمية بأكملها بما يناسب إمكانات الفرد.
عقبات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
المشكلة الرئيسية تكمن في نقص المحتوى العربي السليم على شبكة الإنترنت، وضعف الموارد المتاحة باللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي؛ إذ عندما نتعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، يصبح الوصول إلى المصادر والبيانات محدودًا بشكل كبير مقارنة باللغات الأخرى.
في ظل هذا الواقع يمكن الاستفادة من التجارب باللغات الأخرى في هذا المجال، مدعوماً بالتكييف وتعزيز الابتكار وفق احتياجات لغة الضاد، مثلاً ما تزال مهارات التحدث والاستماع والاستيعاب الأكثر عبئاً على المعلم والطالب بسبب عقبة الوقت والتقييم، لكنّ برنامجاً قائماً على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل المشكلة، كاستعمال القواميس الصوتية الموثوقة لتعلم النطق الصحيح للكلمات بل ولجمل كاملة.
ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل وتقديم ملاحظات حول استخدام القواعد والمفردات، مما يساعد المتعلمين على تحسين مهاراتهم في الكتابة والفهم. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في اللغة العربية، التي تحتوي على قواعد نحوية معقدة ومفردات واسعة.
الطاقم التعليمي والمطورون على السواء يحتاج كل منهم إلى مهارات متقدمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، مما يتطلب استثمارات إضافية في التدريب والتطوير، قبل الانتقال غير المدروس إلى هذا التحول.
لا ننسى أن الذكاء الاصطناعي هو مكمل مهم لعملية التعلّم ومساعد في توفير الوقت على الأساتذة والمتعلمين في توفير بعض المواد التعليمية المساندة، ولا يمكن أن يحل بشكل كامل محلّ المعلّم المتخصص صاحب الخبرة.
وحتى نوضّح تصورنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن نقدم نموذجاً متعلقاً بتعليم قواعد اللغة العربية؛ فاستناداً إلى الإمكانيات المتاحة المشار إليها، يستطيع المعلم المعد جيداً أن يتعامل مع برامج ومساقات تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، بأن تحددها، وتعالجها، وترصد تطور التحسن «الفردي» فيها.
مثلاً في تعليم «كان وأخواتها» يمكن أن يحدَّد الطالبُ الذي يجد صعوبة في تحديد اسمها وخبرها، عند التقديم والتأخير كما في جملة (كان في البيتِ رجلٌ)، أو آخر يخطئ في علامة الإعراب في حالة الأسماء الخمسة والضمائر مثلاً. وهذا ينطبق على موضوعات أكثر تعقيداً في تعليم البلاغة والعروض مثلاً.
المعلم في هذه الحالة ليس مضطراً إلى أن يُخضعَ الطالبَ «غير المحتاج» إلى تعزيز أو إعادة معلومة يعاني طالب آخر مشكلة فيها، ببساطة؛ الذكاء الاصطناعي سيتولى المهمة ويُعلم المعلم بالتطور الذي جرى، وينبهه في حالة الإخفاق.
كما أشرنا يمكن الاستفادة من تجارب اللغات الأخرى، لكن كما هو معروف اللغة العربية في مجملها مُعربة واشتقاقية، وهذا يزيد من تحدي من يتصدى لهذه المهمة؛ سواء على مستوى إعداد «المناهج الجديدة» أو أدوات تعليمها، أو إعداد المعلمين الذين يتعاملون معها؛ نحن أمام مشكلة أكبر من أن تتولاها جهة واحدة أو أفراد، لذلك نرى أن هذا الأمر يتطلب استراتيجية عربية موحدة يتعاون فيها القطاعان العام والخاص والجامعات والمجامع؛ إذ إن الجهود المتفرقة ستزيد تعقيد المشهد، والأهم أنها ستشتت الجهود وتبدد الموارد في حال تكرار أعمال الآخرين، وعدم البناء على ما أنجزوه. والحل كما نراه ببساطة أن تُشكل هيئة عربية تُعنى باللغة العربية والذكاء الاصطناعي، تشكل حاضنة للبحوث والإنجازات في هذا المجال، وتستفيد من تجارب الآخرين، والأهم أن تواكب هذا العالم الذي يكاد التطور فيه يكون يومياً، والقفزات النوعية تتم فيه ربما خلال أشهر معدودات، وفيه من الطبيعي أن تسمع عن تقنية قد مضى عليها عام واحد فقط بأنها «قديمة».
نختتم -لتوضيح خطورة ما نمر به اليوم- بأن نحيل إلى نتائج الدول العربية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا–PISA)، المعني بقياس المستوى في ثلاثة مجالات هي: القراءة، والرياضيات، والعلوم، التي ترتبط بالمعرفة والمهارات الأساسية، التي يحتاجها البالغون في حياتهم، إضافة إلى التركيز على العمل في أي مجال، تحت مختلف الظروف، ويخضع لها الطلاب، الذين بلغ سنهم (15) سنة، الذين هم على وشك استكمال تعليمهم الإلزامي، والاستعداد لمواجهة التحديات، في مجتمعاتهم اليومية.
شاركت المملكة الأردنية الهاشمية في هذا البرنامج منذ وقت مبكر، وكان ترتيبه كما يأتي:
– في عام 2012 احتلت الترتيب 60، والدول المشاركة 65.
– وفي عام 2015 احتلت الترتيب 61، والدول المشاركة 70.
– وفي عام 2018 احتلت الترتيب 56، والدول المشاركة 79.
– وفي عام 2022 احتلت الترتيب 75، والدول المشاركة 81.
بقية الدول العربية ليست عموماً أفضل حالاً، وأظن أن هذه النتائج تدق ناقوس الخطر، وتشي بأن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فيما يتصل بالتعليم عموماً وباللغة العربية بشكل خاص: قراءة، وكتابة، وفهماً؛ وفي التدريس وطرقه؛ وفي المعلمين وكفايتهم؛ وفي المنهج وملاءمته لمستويات الطلبة، ومتطلبات العصر، وعلى رأسها الحاسوب والذكاء الاصطناعي، والمقترح الذي أشرنا إليه يكون بقيام جهة مركزية مختصة على مستوى العالم العربي والتفرغ الكلي للبحث عن حلول لهذه الداهمة الوافدة علينا جميعاً.
 عروبة الاخباري | Oroba News نأتيك بالخبر اليقين !
عروبة الاخباري | Oroba News نأتيك بالخبر اليقين !


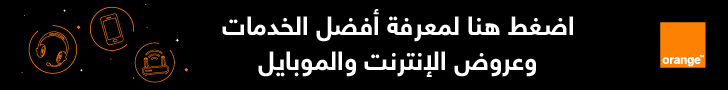
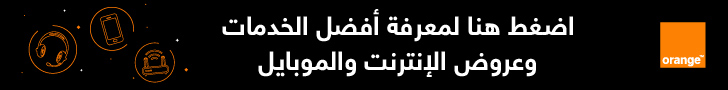




يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.